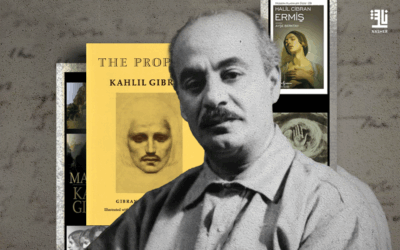بقلم نورة النومان- كاتبة وناشرة وروائية
بدأت علاقتي بالكتب منذ أكثر من 40 عاماً. ذاكرتي تأخذني إلى بيت جدي إبراهيم بن محمد المدفع، رحمه الله، ومكتبته العامرة بالكتب التي كانت تمتد على أرفف تصل إلى السقف. كتب قديمة وثقيلة شكلت بالنسبة لطفلة صغيرة مثلي صرحاً مهيباً، وكان طموحي أن أستطيع قراءتها وفهمها يوماً ما. ومع ذلك، حاولت أن أطلع على بعض الكتب الصغيرة، وفي تلك المكتبة تعرفت على “مجدولين” للأديب مصطفى المنفلوطي، و”أشباح وأرواح”، و”حول العالم في 200 يوم”، و”الذين هبطوا من السماء”، و”الذين عادوا إلى السماء” وجميعها للكاتب أنيس منصور. لا أدري كم كان عمري في تلك الفترة، لكنني أيضاً وقعت في حب قصص الجيب للمغامرين الخمسة، وأدمنت على قراءتها، أنا وصديقاتي في الابتدائية. كان لها تأثير كبير على شخصيتي، حتى شكلنا في مطلع السبعينيات من القرن العشرين مجموعة خاصة بنا من خمس فتيات، نتبارى في العثور على المغامرات، وعلى حل المسائل الغامضة في مدرستنا.
هذا الاهتمام الواضح بالكتب اجتذب انتباه من حولي، فكانت بعض الصديقات يسخرن مني، ليس في الإعدادية والثانوية وفي الجامعة فقط، بل حتى عندما تخرجت، وكنت أجلب معي كتاباً في المدرسة التي كنت أعمل فيها معلمة للغة الإنجليزية. إن من يحبون الكتب ويجلبونها معهم في كل مكان، يعرفون جيّداً تعليقات من حولي عندما كانوا يقولون: “ما بالك وهذه الكتب؟ ما الفائدة منها؟ هل تعتقدين أنك ستغيرين العالم بهذه الكتب؟” وكل تلك التعليقات الساخرة التي كانت توجع، وفي الوقت ذاته تدفعني إلى الانزواء والاختلاء بكتبي التي لا تصدر أحكاماً ولا تبث لي سوى الإيجابية والأمل.
وهذا العام، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله توجيهاته بتخصيص عام للقراءة لأنها “المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين”. ولأن “القراءة تفتح العقول.. وتعزز التسامح والانفتاح والتواصل.. وتبني شعباً متحضراً بعيداً عن التشدد والانغلاق، وهدفنا ترسيخ دولة الإمارات عاصمة ثقافية عالمية بامتياز.. وإحداث تغيير سلوكي دائم.. وتحصين ثقافي للأجيال القادمة”.
وفجأة سكتت كل الأصوات التي كانت تسخر من كتبنا وعشقنا لها.
القراءة تعتمد على وجود الكتاب. هذا الشيء الورقي أو الإلكتروني الذي يحمل بين طياته كل تلك القيم والمعارف التي تحتاجها البشرية للتطور وللاستمرارية. لكن هل الكتاب مخلوق نادر، ينشأ صدفة مثل “الطرثوث” وهو نبات طفيلي معمّر لا أحد يعرف من أين يأتي؟ أم هل هو نتاج انشطار ثنائي، بحيث تتوالد الكتب لتنتج كتباً أخرى؟
لنشوء الكتاب مقومات أساسية لا يمكن أن يخرج بدون توافرها. أولها: الكاتب. فالإنسان لا يولد كاتباً، ولكن قد يولد بملكة الكتابة، ثم يهتم من صغره بالكلمات وبالكتب، ويقرأ كل ما يقع بين يديه حتى يشبع تلك الحاجة لالتهام الكلمات. وفي المدرسة وفي الجامعة يتلقى تلك الدروس والمساقات التي تصقل موهبته، وتقدم له بمنهجية واضحة كل مقومات الكتابة، من الأنماط المتنوعة لها إلى الأساليب المختلفة في السرد إلى بناء الشخصيات الرئيسية ومراحل تطورها في الرواية، والعقدة، والحبكة، والذروة، وقواعد الحوار، وكل ما يتعلّق بأنماط الكتابة. فلننظر إلى مؤسساتنا التعليمية ونبحث عن درس واحد أو مساق واحد في الكتابة الإبداعية. لن نجد.
ثانيها: المحرر. ولا أقصد هنا التدقيق اللغوي، بل التحرير الأدبي. ففي قطاع النشر الغربي، يلعب المحرر الأدبي دوراً محورياً في نجاح الكتاب الأدبي. التقيت بكاتب أمريكي شهير، قرأت له 24 رواية. أخبرته بعنوان روايتي المفضلة فابتسم وقال إنه التقى بالعديد من قرائه وكلهم أجمعوا أنها المفضلة لديهم. ثم أضاف: “هل تعلمين كم مرة أعادها لي المحرر الأدبي لأنها لم تعجبه؟ خمس مرات. ولم تنشرها الدار إلى أن رضي عنها المحرر”. فالمحرر الأدبي يقوم بتفحص عناصر الرواية بعين ناقدة تضع في اعتبارها اكتمال العناصر من أجل نجاحها. والسؤال هو: هل هناك مساق واحد في الجامعات لتعليم التحرير؟
الثالث: المترجم – في حالة نشر كتاب من لغة أخرى. فالترجمة ليست “فهلوة”، بل هي علم وتخصص، وليس كل من يعرف اللغة المصدر واللغة الهدف يمكن أن توكل إليه مهمة ترجمة نص يتم نشره. ثم إن المترجمين يعاملون في قطاع النشر وغيره وكأنهم عبيد سخرة، تدفع لهم مبالغ زهيدة مقابل ترجمة عمل خالد. ولأن المبالغ زهيدة، قد لا يقبل بها المترجم المحترف، ولذلك يوكل بالنص لمن هو أقل قدرة وكفاءة، فيخرج نصاً هزيلاً ينفر منه القارئ العربي. ورغم وجود برامج في التعليم العالي تدرب المترجمين على علم الترجمة إلا أنها مساقات نظرية بينما التدريب العملي قاصر ويحتاج إلى إضافة ساعات تطبيق عملي تضمن تنوع النصوص.
والرابع: الناشر، أو المؤسسة التي تأخذ على عاتقها استلام المسودات وفرزها وانتقاء النصوص المثلى، ثم تحريرها، وعمل التدقيق اللغوي عليها، وغيرها من العمليات الفنية. كل هذه الخطوات مكلفة بالنسبة للناشر، ولا يمكن التقصير باختيار الأفضل في كل مرحلة من هذه المراحل، ما يعني أن التكلفة ترتفع على الناشر. وتبقى هذه الحلقة في سلسلة قطاع النشر مرتكزة على مفهوم أنها مؤسسة تجارية بحتة، يديرها القطاع الخاص كمشروع تجاري شخصي. وكأن الكتاب الذي يغذي عقول أجيالنا ويصنع حضاراتنا يمكن أن يترك فقط في يد مشاريع تجارية خاصة.
أما العنصر الخامس والأخير فهو: الموزع. وفي العالم العربي، يعاني قطاع النشر من سوء التوزيع، فتتوافر كتب في دول، بينما لا يمكن الحصول عليها في دول أخرى. وفي الجانب الآخر، نجد أن الكتب الأجنبية وخاصة الإنجليزية تتوافر في كل دولة، ويمكن طلبها عبر الإنترنت بكل سهولة. والتوزيع عملية مكلفة، ولتغطية تكاليفها تقوم مؤسسات التوزيع برفع سعر الكتاب، ثم يقوم بائع الكتب برفع السعر ثانية لتغطية تكلفة التوزيع والشحن. وينتهي الحال بالكتاب العربي في مكتبة تبيعه بتكلفة عالية يصعب على القارئ العربي أن يتحملها بطريقة تضمن استمرارية تغذية حبه للقراءة. هناك 22 دولة عربية، وشبكة خطوط جوية تربطها كلها. ألا توجد طريقة منظمة لاستغلال هذه الشبكة لنشر الكتاب في كل دولة؟
إن هذا السرد لدورة حياة الكتاب أمر ضروري حتى ندرك أن أعوام وشهور وأسابيع القراءة لا يمكن أن تقوم إلا بتعزيز المنظومة كاملة دون استثناء. وهو عمل لا يمكن أن يقوم به فرد أو جماعة أو مؤسسة واحدة، بل هي ثقافة تتخلل كل جانب من جوانب الدولة من أجل دعم دورة حياة الكتاب – لكي يولد الكتاب الذي يتبادله القراء كل يوم.