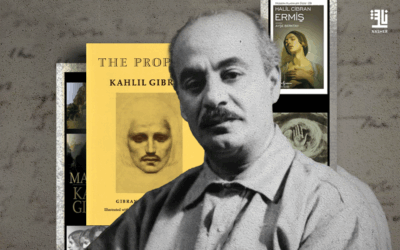التجربة الأولى في النشر.. توقّعات كبيرة وذكريات مريرة
الأردن – جعفر العقيلي
تظل تجربة نشر الكتاب الأول، عالقة بذاكرة المؤلف، بخاصة إن كان أديباً، فهي لا تخلو من بهجات كما لا تخلو من معاناة.
وبينما هناك من يذكر ناشره الأول بكثير من الثناء لأنه قدمه لجمهور القراء وأعلن ولادته إبداعياً، هناك من “يلعن اللحظة” التي قادته فيها خُطاه إلى ناشره، نادماً على اختياره ومقرّاً بـتجربته “المريرة” التي لم تُضف له شيئاً!
هذه المواقف والانطباعات مرتبطة بالتوقّعات والمسافة بينها وبين ما يحدث على أرض الواقع، فالمؤلف يطرق باب الناشر وهو ينتظر منه “الكثير” لتسويق كتابه، بخاصة إن كان قد ساهم مادياً في كلفة الطباعة، وهذا هو الدارج في الغالب الأعم على الساحة العربية.
وفي العادة، تمر عملية نشر الكتاب الأول –كأيّ كتاب- بمراحل تبدأ باختيار المؤلف لناشره، ثم التفاوض لإبرام العقد، ثم المرحلة التنفيذية التي يخضع الكتاب فيها للتصحيح والتنسيق واختيار لوحة للغلاف، ثم تصميم الغلاف، وأخيراً الطباعة التي يُفترَض أن تكون بناء على المواصفات المتفق عليها. وفي سياق هذه العملية تحدث خلافاتٌ واختلافاتٌ في الرأي، منها ما يمكن تجاوزه، ومنها ما يعقّد الأمور ويؤدي إلى توقّف المشروع كله!
يرى الشاعر والروائي الفلسطيني إياد شماسنة أن تجربة النشر الأولى للكاتب العربي توازي تجربة ميلاد الطفل الأول، إذ تكون “عسيرة، متوترة، تحظى بالترقب، ومستوى لا بأس به من الأدرينالين، وبعد ذلك الحب والفرح، ثم العثرات التي تواجه المولود الجديد، والكدمات والإصابات التي تُكتشف بعد خفوت الدهشة وبرود الفرح”.
ولا يخفي شماسنة أن تجربته الأولى بدءاً من قرار النشر، وحتى صدور الكتاب كانت “عسيرة”.. ويوضح: “عسيرة حين ترسل النص، وينتظر شهرين أو ثلاثة أو سنة؛ ليأتي الرد بأن نشر النص بما فيه لا يتوافق مع سياسة الدار، بالطبع هذه السياسة غير معلَنة وليست واضحة أو منشورة في موقع الدار الالكتروني -إن وُجد”.
ويضيف شماسنة أن هذا الرد “قد لا يأتي بعد سنوات، أو قد يأتي مقتضباً بكلمة واحدة لا يليق مخاطبة أديب بها: نعتذر مع الأسف!”.
ومما يكتشفه المرء وفقاً لشماسنة، أن الناشر ربما يتمثّل في أحد هؤلاء الذين ينوبون عنه: السكرتيرة، ولجنة القراءة، والمدقق الإملائي، وأحياناً مصمم الأغلفة للكتب، أو أخته أو زوجته، والمحاسب الذي يقبض ثمن نشر الكتاب بدل دفع مقابل شراء حقوق النشر!
ويصف هذا الشاعر فرحته عندما حظي بخطاب مهني من ناشره الفعليّ الذي استجاب لرسالته بعد ثلاثة أيام من مراسلته، ونشر له ديوانه الأول، بعد سنوات من الانتظار وبعد مراسلات طويلة مع ناشرين في دول عربية مختلفة، بعضها كانت بتوصيات من كتّاب كبار.
ويقول شماسنة: “رغم فرحي بالإنجاز الجديد، طرحتُ توقعاتي جانباً بما اختبرت الحالَ والسوق من قبل، واستقبلت كل حدث بقلب بارد، إذ تعلمتُ أن أكون واقعياً”.
وبعد أن استقبل قراؤه كتابه الأول ببعض الملاحظات، تعلم شماسنة كيف يعتمد على نفسه بأن ينجز “كل شيء”، بدءاً من تصميم النص، مروراً بصف المادة الأدبية أو العلمية وتنسيقها، وانتهاء بالحصول على تفويض باستخدام لوحة الغلاف من صاحبها، ومع ذلك، يقول شماسنة: “أصدرتُ كتابي الخامس وأنا أكتشف أننا ما زلنا بحاجة إلى نهضة جديدة ومختلفة تماماً لصناعة النشر والتوزيع في العالم العربي”.
بدوره، يقول الشاعر والباحث الأردني المقيم في سلطنة عُمان محمد محمود بشتاوي، إنه وجد نفسه مدفوعاً لنشرِ كتابه الأول لأسبابٍ كثير؛ إذ كتب مجموعة قصائد في مطلع الألفية الثالثة، ثم ركنها في الدرج، وراكم فوقها قصائد متفرقة، إلى أن جاء عام 2009، فرأى أنه تأخر في نشرِ نتاجه الذي تشكّل من النقد أيضاً إلى جانب الشعر، وشعر أنه “ملزَم في التخلّصِ من هذا المخزون”؛ فأتلف بعضه، ونسّق جزءاً آخر في مخطوطِ شعري حمل عنوان “كأن المسافةَ وهمٌ”، نشره بدعمٍ -ماليّ- من وزارة الثقافة الأردنية.
“بقي أمرُ اختيار الناشرِ”؛ يقول بشتاوي مضيفاً: “نظرت حولي، واطلعت على تجارب أقراني، فكانت هناك دارُ نشرٍ جديدة قد دشّنت مجموعة من الكتب، وروجتْ لمشروعها الثقافي، كما أنها لم تطلب من المؤلفِ مالاً كثيراً نظير عملها، بل حفزت على الإقبال عليها، فهي تطبع، وتسوّق، وتروّج إعلامياً للكتاب المطبوع، وتخصص نسبة أرباح للمؤلف”.
لكن ذلك كله “كان مجردَ وهم” بحسب بشتاوي، الأمر الذي باعد بينه وبين ناشره الأول في الإصدارات اللاحقة. وهو يتذكّر هنا “التسويفَ” الذي مارسهُ الناشر، فمجموعة شعرية من 140 صفحة، “تطلبت ستة شهور من الوقت حتى خروجها من المطبعة”! ثم تفاجأ الشاعر أن الكتاب المطبوع أقرب في جودته إلى الكتب المنسوخة تصويراً، علاوة على أخطاء في الطباعة -في بعض النسخ، فضلاً عن أن الترويج الإعلامي لم يتحقق.
ويبين بشتاوي أن عمله في الصحافة “لحسن الحظّ”، سهّل عليه توزيع خبر صحفي عن صدور كتابه، نشرته المواقع والصحف في حينه.
اليوم، وهو ينظر إلى تلك التجربة؛ تجربة شخص لم يبحث في “بروفايل” الناشر، يجد بشتاوي أن هذه المؤسسات، وهي كثيرة، يفتقد بعضها للمصداقية، وللجدية في التعامل مع المؤلفين بشكلٍ سويٍّ؛ فهناك –بحسبه- ناشرون يميزون بين الذكر والأنثى، وبين الكبير والصغير، وبين الفقير والغني، وهناك منهم من “لا يملكُ برنامجاً لمشروعهِ في النشر”، لهذا فإن بشتاوي حين يرشحُ ناشراً لمؤلفٍ صديق، لن يرشح -كما يقول- إلّا من وثق في تجربته، وما لمسه في هذا المجال من عمل مبنيٍّ على الجودة والمصداقية.
أما الشاعر والكاتب المغربي عبدالله المتقي، فيقول حول تجربته مع الكتاب الأول من خلال مؤسسة ثقافية رسمية (مديرية الثقافة): “إنها تكاد تكون أشبه بالحب الأول: بهجة وبعدها معاناة”، ويضيف: “قصائدي الأولى كانت تمارين شعرية محتشمة ضممتُها في مخطوط، ثم عنونتها بـ (قصائد كاتمة الصوت)، تأبطتُها وقصدتُ مديرية الكتاب لينُشَر بعدها ضمن سلسلة الكتاب الأول، وحتى أُعفَى من شَرَهِ الناشرين وجشعهم”، ويوضح أنه تلقى لاحقاً رسالة من المديرية ، من أجل التصحيح وتوقيع العقد الذي ينص على أن يتسلم من ديوانه ثلاثين نسخة ومبلغاً مالياً يصل إلى خمسمئة دولار.
ويتابع الشاعر بقوله: “كان التصحيح الأول، ثم تلقيت مكالمة هاتفية من المديرية للتصحيح الثاني، ما يعني أن عليّ تحمُّل مشاق السفر، في الوقت الذي يمكن فيه إجراء التصحيح الكترونياً، فللمديرية بريد الكتروني، ولي بريد الكتروني أيضا”.
رغم ذلك كله، خرج الديوان، لكن دون استشارة صاحبه تماماً، “لا في شكله ولا حتى لوحة غلافه”، بل إن حصول الشاعر على نسخه الثلاثين كلّفه “أكثرَ من سباقٍ للمسافات”، أما الشيك بقيمة المكافأة فله “قصة أخرى”، تطلّبت منه السفر للعاصمة مرة تلو أخرى، وليس سوى الاعتذار و”التسويف”.
هكذا تحقق الحلم الذي سكن صاحبه طويلاً وأصبح بالإمكان أن يشار له بأنه شاعر، لكن بعد تعب وخطوات شاقة، والأنكى -الغريب والعجائبي معاً- أن الديوان بقي مركوناً في مخازن المديرية التي لم تكلّف نفسها توزيعه في سوق القراءة، فعلى للقارئ انتظار المعرض الدولي للكتاب للحصول على نسخته.
لكن المتقي يؤمن أن هذه التجربة –على مرارتها- تظلّ أخف وطأةً من تلك التي يكون طرفُها الآخر ناشراً “يجيد نصبَ الفخاخ” للمؤلف.
وتسرد الكاتبة سامية العطعوط حكاية نشر كتابها الأول، التي كانت من دون استعانة بناشرٍ، قائلةً: “إنها أعدّت مخطوطة قصصية بانتظار النشر في عام 1985، ولم تكن تعرف شيئاً عن دور النشر، بخاصة إنه لم يكن يتوفر الكثير من دور النشر في تلك الفترة، فالتفتت حولها لتكتشف أنها “وحدها” مع المخطوط”.
وتضيف: “كنت أعمل في البنك العربي الذي كان يتعامل مع إحدى المطابع، فقررت نشر الكتاب في المطبعة على حسابي. اعتقدتُ أن هذا ما يفعله الكتّاب وهذا ما يجب أن أفعله!”.
كانت المطبعة حديثة وبإمكانيات ممتازة بحسب العطعوط التي قامت بتحرير الكتاب، وساعدها أحد الأصدقاء في اختيار ما سيُنشر من بين مجموعة كبيرة من القصص. أما الغلاف، الذي حددّت هي بنفسها فكرته، فقد قام فنان تعرفه برسم لوحته.
وحين طُبع الكتاب بألف نسخة، لم تعرف العطعوط ماذا تفعل بها. وتوضح: “وجدت عشرات من الصناديق مكوّمة عندي، فقمتُ بتوزيع النسخ على الزملاء في البنك بسعر دينار للنسخة الواحدة، وكانت كلفة النسخة لا تزيد عن ثلاثين أو أربعين قرشاً. وساعدتني إدارة البنك في شراء عدد من النسخ لتوزيعها مجاناً”.
بالنتيجة، استطاعت العطعوط أن تستعيد مصاريف الطباعة خلال أقل من شهرين، وبدأتْ بتوزيع معظم بقية النسخ مجاناً، وللمفارقة كان هذا هو الكتاب الوحيد الذي استفادت منه مادياً من خلال البيع المباشر.